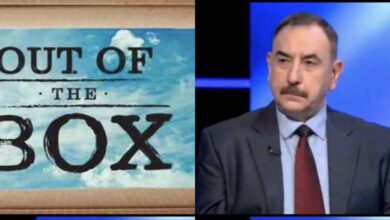الصين تبحث عن حلفاء
الصين تبني تحالفات واسعة منافسة لما لدى القوى الغربية

جنود صينيون في مسيرة الاحتفال بـ”يوم النصر” في موسكو، 24 يونيو (حزيران)، 2020. (رويترز)
لطالما شكّلت شبكة تحالفات الولايات المتحدة ركيزة أساسية في سياستها الخارجية، ويُشار إليها كميزة مهمة للولايات المتحدة، في ظل اشتداد المنافسة مع الصين في السنوات الأخيرة. وقد ركزّت إدارة الرئيس جو بايدن بشكل خاص على الحلفاء في استراتيجيتها الخاصة بآسيا. وعمدت الإدارة في سنتها الأولى إلى تقوية التحالفات الموجودة منذ مدة طويلة كتلك التي تربطها مع اليابان وكوريا الجنوبية، وكذلك كرّست مقداراً كبيراً من الطاقة لتعزيز الشراكات المتعددة الأطراف كـ”الحوار الأمني الرباعي” (مع أستراليا، والهند، واليابان) وكذلك “حلف أوكوس” الذي جرى إنشاؤه حديثاً (مع أستراليا والمملكة المتحدة).
وعلى النقيض من ذلك، نأت الصين بنفسها عن التحالفات الرسمية، وذلك انطلاقاً من نظرتها الفريدة المفترضة إلى العلاقات الدولية ورغبتها البراغماتية في تجنب مخاطر التورط العميق. في المقابل، ثمة دلائل على أن مقاومة بكين [لبناء هذه التحالفات] شرعت في التآكل. وفي سنوات أخيرة، عمدت إلى رفع مستوى شراكاتها، ووسعت نطاق التبادلات العسكرية والمناورات المشتركة مع دول من بينها روسيا وباكستان وإيران. وتبقى تلك الشراكات بعيدة كل البعد عن تحالفات الولايات المتحدة (التي تشمل بنود دفاع متبادل، واتفاقات واسعة النطاق بشأن تمركز القوات، وقدرات عسكرية مشتركة). في المقابل، تستطيع [الشراكات الصينية] أن تشكل مع الزمن الأساس لشبكة تحالفات خاصة بالصين، إذا انتهى قادتها إلى الاقتناع بأن أداة كهذه ضرورية لأنها تتمتع بالقدرة على الردع من ناحية، وأيضاً نتيجة قيمتها العملانية من أجل التفوق في المنافسة على المدى الطويل مع الولايات المتحدة وحلفائها من ناحية أخرى. وإن تطوراً كهذا من شأنه أن يمثل نقطة تحول حقيقية في عصر المنافسة بين الولايات المتحدة والصين ويمهد الطريق أمام عالم جديد مثير للقلق، يصبح فيه اندلاع صراع إقليمي وصراع قوى عظمى، أكثر إمكانية مما مضى.
الصين تنشئ شبكة خاصة بها
لدى الصين حالياً حليف رسمي وحيد، هو كوريا الشمالية التي تجمعها بها معاهدة دفاع مشترك. لكنها، عقدت عشرات الشراكات الرسمية مع دول في شتى أنحاء العالم. وعلى رأس الهرم في تلك الشراكات، تتربع روسيا وباكستان (اللتان يشار إلى علاقاتهما الخاصة للغاية مع بكين بألقاب طويلة وحصرية، على شاكلة “الشراكة الاستراتيجية الشاملة للتنسيق بين الصين وروسيا من أجل عصر جديد” و”الشراكة التعاونية بين الصين وباكستان في كل الأحوال”. ثم يأتي دور دول عدة في جنوب شرقي آسيا على غرار ميانمار وكمبوديا وفيتنام وتايلاندا ولاوس، إضافة إلى بلدان على مسافة أبعد من تلك الدول، تشمل مصر والبرازيل ونيوزلندا. وقد استثمرت بكين مقداراً كبيراً من الجهود في بناء آليات متعددة الأطراف بقيادة الصين، كـ”منظمة شانغهاي للتعاون” (سكو)، و”منتدى التعاون الصيني الأفريقي”، و”منتدى التعاون الصيني- العربي”.
ولقد تفادت الصين بناء شبكة تقليدية من الحلفاء حتى الآن، لأسباب عدة، تتراوح بين الميول الأيديولوجية الطويلة الأمد والحسابات الاستراتيجية العنيدة. ومنذ الأيام الأولى للجمهورية الشعبية، سعت بكين إلى تصوير نفسها كقائدة للعالم النامي وداعمة لمبادئ حركة عدم الانحياز في عدم التدخل ومعاداة الإمبريالية. وفي السنوات القليلة الماضية، بدأ القادة الصينيون بالإصرار على أنهم يمارسون “نوعاً جديداً من العلاقات الدولية” متجنبين سياسات القوة التقليدية لمصلحة “التعاون المربح للجانبين”. وتهدف هذه اللغة إلى تعزيز الرواية القائلة بإن صعود الصين ينبغي ألا يدعو إلى القلق، بل يجب أن يكون موضع ترحيب باعتباره نعمة بالنسبة إلى التنمية والازدهار العالميين. كذلك ترمي [تلك السياسة] أيضاً إلى تمييز بكين عن واشنطن التي كثيراً ما ينتقدها القادة الصينيون بسبب حفاظها على “عقلية الحرب الباردة” التي عفا عليها الزمن [وفق تعبيرهم].
نسجت الصين تحالفات مع عشرات الدول في أرجاء العالم
وإضافة إلى جهود الدبلوماسية العامة هذه، فإن موقف بكين المتحفظ على إقامة تحالفات، يعبّر عن قرار استراتيجي لها ببناء علاقات تتمحور حول العلاقات الاقتصادية، في إطار سعيها إلى مزيد من السلطة والنفوذ العالمي. ولا يعني ذلك أن الصين تستخدم فن الدولة الاقتصادي وحده من أجل تحقيق أهدافها. وفي الواقع، سعت بكين إلى توسيع قدراتها العسكرية على امتداد العقدين الماضيين، واستخدمت قوتها الجديدة في ترهيب تايوان، والتنافس مع الهند على طول حدودهما المتنازع عليها، والإلحاح على مطالبها السيادية في بحري الصين الشرقي والجنوبي. وعلى الرغم من ذلك، في حين يعتبر القادة الصينيون القوة العسكرية ضرورية لحماية وطنهم، ومصالحهم الوطنية الأساسية، ومواطنيهم واستثماراتهم في الخارج، إلا أنهم أظهروا القليل من الرغبة في تحمل التزامات أمنية خارجية قد تجر بلادهم إلى صراعات صعبة المنال أو في مناطق نائية.
وبدلاً من ذلك، راهنت بكين على أن تقديم القروض، والاستثمارات، وتوفير فرص التجارة، وممارسة الأعمال التجارية مع أي كيان سيادي، بغض النظر عن شخصيته وسجله في وطنه، من شأنها أن تجعل الصين تكسب مزيداً من الأصدقاء والنفوذ. وقد أتت هذه الاستراتيجية أُكُلها. وقد رحّب عدد من حلفاء الصين، خصوصاً في العالم النامي، بطريقة انخراطها معهم ودعموا مصالحها الأساسية لقاء ذلك. واستطراداً، يميل هذا الدعم إلى أن يكون في الأساس ذو طبيعة ديبلوماسية، كالتأكيد مثلاً على مبدأ “الصين الواحدة” في بكين، والتزام الصمت أو حتى الإشادة بسياساتها القمعية في مقاطعة “شينجيانغ” [ضد الأويغور]، وإقرار الأجندة التي تتبناها الصين في المحافل الدولية المتعددة الأطراف كالأمم المتحدة. وإلى جانب توفيرها الحوافز الاقتصادية، أخذت بكين تستعمل بشكل متزايد أسلوب الإكراه الاقتصادي في معاقبة الدول التي تتحدى مطالبها، على غرار ما فعلته مع أستراليا التي فرضت الصين رسوماً جمركية باهظة على صادراتها، بعدما حظرت [أستراليا] شركة الاتصالات الصينية العملاقة “هواوي” من شبكاتها ودعمت تحقيقاً دولياً في أصل فيروس “كوفيد- 19”.
حسابات بكين المتغيرة
يبدو من المستبعد أن تتخلى الصين تماماً على المدى القريب، عن استراتيجيتها الجغرافية الاقتصادية في الهيمنة. لكن، ثمة إثنان من السيناريوهات المحتملة يمكنهما أن يدفعا بها إلى بناء شبكة حسنة النية من الحلفاء. ويتمثل السيناريو الأول في إدراك بكين أن هناك تدهوراً حاداً بدرجة كافية في بيئتها الأمنية يمكنه أن يقلب حسابات الربح والتكلفة المتعلقة بالسعي إلى إقامة أحلاف عسكرية رسمية. ويتجسّد السيناريو الثاني في اتخاذها قراراً بإزاحة الولايات المتحدة من موقعها كقوة عسكرية مهيمنة، ليس فقط في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وحدها، بل أيضاً على مستوى العالم (بالطبع لا يتناقض هذان السيناريوهان مع بعضهما بعضاً).
وقد يتوصل القادة الصينيون إلى استنتاجات مماثلة كتلك الواردة آنفاً إذا قدّروا أن الدفاع عن مصالح “الحزب الشيوعي الصيني” الأساسية، على شاكلة إمساكه بمقاليد الأمور في البلاد، وسلطته في “شينجيانغ” والتيبت وهونغ كونغ، ومطالباته بالسيادة على تايوان، لن يكون ممكناً من دون إنشاء أحلاف مع الشركاء الرئيسين كروسيا وباكستان، أو إيران. وفي الواقع، بدأت التقييمات الصينية تتحرك فعلاً في هذا الاتجاه. ومثلاً، غالباً ما يشير التفسير الصيني بشأن تعميق العلاقات الصينية- الروسية في السنوات الأخيرة، إلى “التطويق” المتنامي مِن قِبَل الغرب باعتباره محركاً أساسياً في ذلك التوجه، كذلك يشدّد [التفسير الرسمي] على حاجة بكين وموسكو إلى العمل معاً من أجل التصدي للتحالفات التي تقودها الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن بكين تستمر في الإصرار على أن الصين وروسيا “ليستا حليفتين”، فإنها قد بدأت تؤكد في الوقت نفسه، أنه “لا توجد مناطق مقيّدة” [أمام تعاونهما] و”لا يوجد حدّ أعلى” في شراكتهما.
احتضنت الصين “الدول المارقة”
أجرت الصين وروسيا منذ عام 2012 تدريبات عسكرية موسعة بصورة متزايدة، بما في ذلك تمرينات القوى البحرية المنتطمة في بحري الصين الشرقي والجنوبي. وجرت تلك التدريبات في بعض الأحيان بالاشتراك مع طرف ثالث كجنوب أفريقيا وإيران. وفي الشهر المنصرم، تصدر البَلدان عناوين الصحف مع الإعلان عن إجرائهما أول دورية مشتركة لهما في غرب المحيط الهادئ. وذكرت صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية الشعبية المُدارة من الدولة، إن تلك الدورية استهدفت الولايات المتحدة لأنها “تتحد مع حلفاء كاليابان وأستراليا [ضد الصين]”. ومن المؤكد أن التاريخ الهش للصداقة والمنافسة بين بكين وموسكو، والقيمة التي توليها كل منهما للاستقلال الاستراتيجي، قد يحدّان من المدى الذي يمكن أن تبلغه شراكتهما. مع هذا، من الجائز أن تبرم الدولتان صفقة بشأن تقديم المساعدة المتبادلة، بدءاً من الدعم اللوجستي ووصولاً إلى المساعدة المباشرة، ويشمل ذلك “المنطقة الرمادية” أو العمليات العسكرية التقليدية، وذلك إذا اعتقدت أي من الحكومتين أنها تواجه تهديداً وجودياً.
وثمة مثل آخر على موقف الصين المخاتل يظهر في احتضانها لـ”دول مارقة”. ومثلاً، بدأ القادة الصينيون في توصيف العلاقات بين الصين وكوريا الشمالية بنبرات مختلفة بشكل صارخ عما كانت عليه قبل سنوات قليلة، حينما جهدت الصين في النأي بنفسها عن بيونغ يانغ. وقد جدد الحليفان في يوليو (تموز) الماضي معاهدة الدفاع المشترك بينهما، وتعهدا العمل على الارتقاء بتحالفهما إلى “مستويات جديدة”. وفي وقت سابق من هذه السنة، أبرمت الصين أيضاً اتفاق تعاون لـ25 عاماً مع إيران، يشمل مشاريع اقتصادية واستثمارات في مقابل الوصول إلى النفط الإيراني. وتعهّد البَلدان أيضاً تعميق التعاون بينهما من خلال تبادلات عسكرية مشتركة، وتبادل المعلومات الاستخباراتيه، وتطوير الأسلحة. وأيّدت الصين بعد فترة قصيرة، طلب إيران نيل العضوية الكاملة في “منظمة شنغهاي للتعاون”، وذلك بعد 15 عاماً من تقديم طهران طلبها الأولي للالتحاق بالمنظمة. وطبقاً لمحللين صينيين، تجنّبت بكين ذلك الطلب ما يزيد على عقد من الزمن حرصاً منها على عدم إزعاج واشنطن، وكذلك بهدف عدم إعطاء انطباع بأن “منظمة شنغهاي للتعاون” تهدف إلى مواجهة الولايات المتحدة. في المقابل، قررت بكين أن تمضي قدماً في دعم طلب طهران بعدما خلُصت إلى أن “سياسة الاحتواء” التي تتبعها واشنطن حيال الصين ستبقى سارية.
وعلى الرغم من أنه لم يتضح تماماً بعد مدى “التحديث” الفعلي الذي ستخضع له تلك الشراكات، إلا إن مثل تلك التطورات توحي أن بكين ترغب في عدم التورط بشكل عميق جداً مع أطراف فاعلة كإيران وكوريا الشمالية، وذلك لأسباب استراتيجيه وأخرى تتعلق بصورتها. من جهة أخرى، قد تتآكل تلك الأسباب بصورة تدريجية إذا تصوّرت الصين أنها أمام بيئة خارجية معادية لها بشكل متزايد، الأمر الذي يجعل حشد الحلفاء ضرورة أكثر إلحاحاً بالنسبة لها. (هذا على الرغم من أن الأسئلة المطروحة حول مصداقية تلك الأطراف الفاعلة والشكوك التي تشعر بها حيال الصين، إضافة إلى عوامل أخرى، تعقّد ذلك الأمر). هكذا، يمكن جداً للقادة الصينيين أن يقرروا في المستقبل المنظور أن الطريقة الأفضل في حماية مصالحهم والتصدي للضغط من جانب واشنطن وحلفائها، تتمثّل في أن تصبح بلادهم قوة عسكرية لا غنى عنها ضمن شبكة حلفائها الخاصة، تماماً على غرار ما فعلته الولايات المتحدة قبل ما يزيد على 70 عاماً.
من المؤكد أن محاكاة قواعد اللعب التاريخية التي طبقتها الولايات المتحدة لن تكون سهلة. وعلى أي حال، فإن معظم الاقتصادات المتقدمة في العالم باتت فعلاً متحالفة رسمياً مع للولايات المتحدة. وتواجه بكين أيضاً شكوكاً عميقة في أنحاء العالم بشأن نواياها البعيدة المدى وميلها إلى الهيمنة. وهذه هي الحال حتى بالنسبة إلى أقرب شركائها في مبادرة “الحزام والطريق”. وقد أعرب عدد من الدول بوضوح عن عدم رغبته في المواءمة الحصرية مع بكين أو واشنطن. في المقابل، إن الوضع الراهن ليس ثابتاً، وتعمل الصين بسرعة على عقد الروابط مع اقتصادات متقدمة ودول نامية، وتحاول أيضاً دق أسفين بين الولايات المتحدة من جهة، وحلفائها وشركائها من جهة أخرى. وحتى إذا لم تقدر على اجتذاب بعض اللاعبين إلى جانبها، فمن الممكن أن تدفع باتجاه الـ”فَنْلَندَه” Finlandization [تكرار نمط علاقتها مع فنلندا] في مناطق استراتيجية رئيسة كشبه الجزيرة الكورية وبعض أجزاء جنوب شرقي آسيا، بمعنى أن تجعلها تطيع السياسة الخارجية الصينية في الوقت الذي تسمح لها بالاحتفاظ ببعض الاستقلالية. بالتالي، فمن شأن ذلك أن يجبر دولاً على التخلي عن روابطها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.
للتحالفات تبعات
إن الخطوات العظيمة التي خطتها إدارة بايدن من أجل إعادة تنشيط تحالفات الولايات المتحدة وزيادة مساهمات حلفائها في أمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ، تشكّل إجراءات أساسية في هذا العصر الذي يشهد تحولاً في موازين القوى والمنافسة الاستراتيجية. في المقابل، يجب أن يدرك بايدن أنه حينما يتعهد قادة الولايات المتحدة إعادة تصوّر تحالفات واشنطن والعمل في سبيل “رؤية جديدة للقرن الـ21” بشأن “ردع متكامل”، فمن الممكن جداً أن تسعى بكين إلى الشيء نفسه مع شركائها الاستراتيجيين.
واستطراداً، لا يعني ذلك أنه يتوجب على واشنطن أن تنأى بنفسها عن حلفائها على أمل أن يؤدي ذلك إلى جعل سلوك الصين أكثر اعتدالاً. وعلى أي حال، ستستند خيارات الصين بشكل رئيس إلى رؤيتها ومصالحها الاستراتيجية الخاصة. ومع ذلك، فمن الأفضل أن تفكر إدارة بايدن في مدى تأثير نجاحاتها بشأن حشد أصدقائها، في تصور بكين أنها عرضة للتهديد، وفي إمكانية أن تحفزها [تلك النجاحات] عن غير قصد، على إيجاد شبكة تحالف منافس بقيادة الصين.
ينبغي التفكير بشكل جدي في كيفية التعايش مع نتيجة كهذه، أو بالأحرى في منع حدوثها. ويجب أن تشمل الجهود المبذولة على هذا الأساس، الطرق الكفيلة بجعل الصين تواصل استثمارها في علاقات مستقرة مع الولايات المتحدة وحلفائها، وضمان التعامل [من جانب أميركا] مع طيف واسع من الدول، وألا يقتصر ذلك على الديمقراطيات التي تفكر بطريقة مشابهة [لأميركا]، بحيث لا يمكن لمن هم خارج دائرة أصدقاء الولايات المتحدة التقليديين، أن يستنتجوا أن الخيار الأفضل بالنسبة لهم يتمثّل في التوافق مع بكين. سيكون بُعدُ النظر والتخطيط الاستراتيجيان ضروريان في منع الانجراف نحو عالم منقسم حقاً، مع كتلة معارضة تقودها الصين الأكثر تورطاً وحرصاً على التدخل.
باتريشيا أم. كيم هي زميلة مؤسسة “ديفيد أم روبنشتاين” في “مركز جون أل. ثورنتون عن الصين”، وكذلك “مركز دراسات سياسات شرق آسيا” في “معهد بروكينغز”.
فورين آفيرز
نوفمبر (تشرين الثاني)/ ديسمبر (كانون الأول) 2021
المصدر اندبندنت عربية
3/12/2021